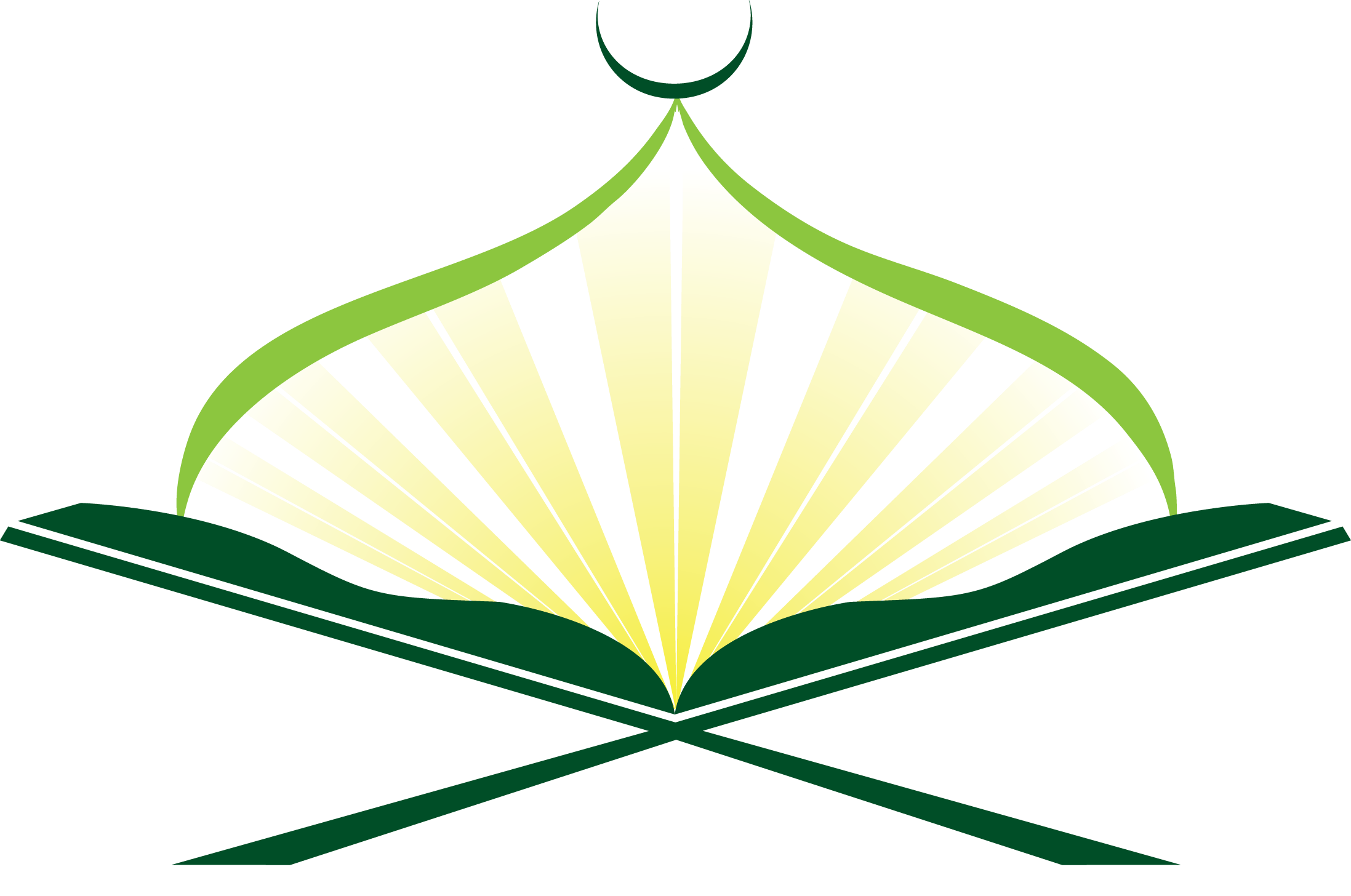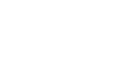إنه لا يحب المعتدين..

ترتبط العبادة ارتباطاً وثيقاً بالأخلاق، فالعبادة لها أثرها الكبير في تزكية نفس المسلم وتوجيه سلوكه، وتهذيب أخلاقه وتقويمها.
ولو تأمّلنا النصوص الشرعيّة والتوجيهات الربّانيّة لاتضح لنا مدى اهتمام الإسلام بتهذيب النفس وتخليصها من أدرانها، وذلك من خلال ما تدل عليه تلك النصوص والتوجيهات من عدم جدوى العبادة إذا لم يكن لها أثر في تهذيب نفس صاحبها وتوجيه سلوكه، فقد دلّت تلك النصوص أنه لا تنفع المرء صلاته ولا صيامه ولا أي شيء من عمله الصالح إن كان سيء الخلق لا يكترث بالاعتداء على الناس وإلحاق الأذى بهم؛ ومن هنا جاء في الحديث الشريف: « المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمونَ مِن لسانِه ويَدِه، والمهاجرُ مَن هَجَرَ ما نَهى اللهُ عنه »، وجاء في الحديث الشريف أيضاً أن رجلاً قال: يا رسول الله إن فلانة تُذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «هي في النار» . قيل: يا رسول الله إن فلانة تُذكر من قلّة صيامها وصلاتها، وأنّها تتصدّق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال: « هي في الجنة ».
لقد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه الاعتداء على الناس أو إلحاق الضرر بهم في نفوسهم وأعراضهم، أو في أموالهم وأهليهم، ودلّت النصوص الشرعية على أن أذيّة المسلم والاعتداء عليه أو على ماله أو عرضه يترتّب عليه أكبر الخطر وأعظم الضرر، ليس على المعتدى عليه وإنما على المعتدي نفسه، وذلك لما للاعتداء من أثر في الإفلاس يوم القيامة من الأجور والحسنات، وخسران النفس باستحقاق العذاب والخلود في النار والعياذ بالله، يقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)، وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوماً فقال: « أتدرون من المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: « المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار ».
ولأن العدوان من أهل الإيمان إنما يكون في الغالب بسبب ردّة الفعل إثر اعتداء من كافر أو ظالم ؛ فقد أوصى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن لا يسوقهم الانتصار للظلم الواقع عليهم إلى تجاوز الحد في رد العدوان بعدوان أكبر - حتى لو كان المعتدي كافراً - حتى لا يكون ذلك سبباً في دخولهم في الظلم والعدوان من حيث لا يشعرون، وحينئذٍ يتحوّل المسلم من مظلوم إلى ظالم، ومن مُعتدى عليه إلى متعدٍّ وباغٍ، يقول الله تعالى: :( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ).
وإذا كان الإسلام قد نهى عن العدوان على المعتدي الظالم فبالأولى الاعتداء ابتداءً دون مبرّر ولا سبب على من ليس بمعتدٍ ولا ظالم، إذ أن قتال الكفار وجهادهم في شريعة الإسلام إنما شُرع ردًّا للعدوان، ودفاعاً عن النفس والدين والوطن، يقول الله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ – أي حيث وجدتموهم يقاتلونكم - وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )، وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ).
وهذه الآيات ونحوها تدل دلالة واضحة على وجوب مراعاة حرمة الإنسان وقداستة، لا فرق في ذلك بين المؤمن وغير المؤمن، والمسلم وغير المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على النفس المحترمة بدون حق بالقتل ونحوه مهما كانت المبررات والأعذار، ومما يعضد ذلك ويؤكّده أن النهي في القرآن والسنة عن سفك الدم وقتل النفس لا يأتي إلاّ بهذا اللفظ الدال على العموم، قال تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ)، وقال تعالى:( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، هذا بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تشير في مضمونها إلى تحريم قتال الكفّار والتعدّي عليهم دون حق، ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا )، وقوله تعالى:(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: 190]، وقوله تعالى:(وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم) [البقرة: 191، 192].
يضاف إلى ذلك ما ورد في الحديث مما يدل على تحريم قتل الكافر المُعاهَد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً - وفي رواية: رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ - لَمْ يَرِح رَائِحَة الْجَنَّة»، وقوله صلى الله عليه وعلى آله: «مَنِ ائْتَمَنَهُ رَجُلٌ عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيّء، وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً».
وأما ما ورد في شأن قتل المؤمن والاعتداء عليه فأمر غير خافٍ على من له أدنى اطلاع ومعرفة بنصوص الشرع وأحكامه، حيث يقول الله تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ) إلى قوله:(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )، وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك!، ما أعظمك وأعظم حرمتك!، والذي نفس محمد بيده لَلمؤمن أعظم حرمةً منك ؛ ماله، ودمه، وأنْ يُظن به إلاّ خيرا ».
ولقد ذهب الإسلام في النهي عن أذيّة المؤمن والاعتداء عليه وإلحاق الضرر به إلى أبعد من ذلك حيث نهى عن ترويع المسلم وإخافته ولو على سبيل المزاح، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ » وفي حديث آخر: « لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِى يَدِهِ فَيَقَعَ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ »، والمعنى لا يجوز للمسلم أن يوجّه سهماً أو سيفاً أو أي سلاح كان إلى أحد من إخوانه المؤمنين بقصد اللعب والمزاح، ولو كان المشير بالسلاح مازحاً، ولو كان من يمازحه أخاه من أبيه وأمه، وإن لم يكن فيه تهديد أو توجّه لإلحاق الأذى به، لأنه قد يقع المحذور فيقتل نفساً بخير حق، ويتحمّل الوزر عند الله، وحينها لا ينفع الندم، فاللعب بالسلاح وتوجيهه نحو صديق أو قريب أو غريب ولو مزاحاً والتهاون في ذلك أو في تعاطي السلاح دون أن يؤمّن أقل أحواله أنه يؤدّي إلى إلحاق الأذى بالمسلم هذا اذا لم يؤدِّ إلى قتله.
ولقد تجاوز تحريم الأذى والعدوان في شرع الإسلام عالم الإنسان إلى أجناس الحيوان، ففي الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «عُذِّبت امرأةٌ في هرَّةٍ سجنتْها حتى ماتت، فدخَلتْ النَّار، لا هيَ أَطْعَمتها وسقتها - إِذ هي حَبسَتها - ولا هي تَرَكَتها تَأكُل مِن خَشاشِ الأرض»، وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ عليه حمار قد وُسم في وجهه فقال صلى الله عليه وعلى آله: « لعن الله الذي وسمه ».
واذا كان الإسلام قد حرّم قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها، وحرّم تعذيب الحيوان وأذيته , ونهى عن أذية المؤمن ولو بالمزاح بالسلاح واللعب به ؛ فكيف بمن يروّع الناس ويستهدف أرواح الأبرياء ؛ ويقتل الأنفس البريئة بغير حق؟! لا سيما إذا كانت ذلك بوسائل التدمير الرهيبة التي تستخدم اليوم من طائرات وصواريخ ومتفجرات وما إلى ذلك!! وهل يصح أن يُنسب من يرتكب مثل هذه الجرائم إلى الإسلام، أو ينسب مثل هذا العمل إلى الدين؟!! (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ) .
ومثلما نهى الإسلام عن الاعتداء على النفس بالقتل دون وجه حق فقد نهى الإسلام كذلك عن التعدي على الحق العام والمشاريع العامة الحيوية التي تتعلّق بها مصالح الناس ومعايشهم، ومن ذلك: الطرق العامّة، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ومشاريع الدولة ومؤسساتها الخدمية وغير الخدمية، ومنها مشاريع النقل، والكهرباء، والمياه، وأنابيب النفط وناقلاته، وما إلى ذلك من المشاريع العامّة والمؤسسات الخدمية التي تهدف في الغالب إلى خدمة المجتمع ورعاية مصالحه.
وما من شك أن الاعتداء على مثل هذه الخدمات والمشاريع هو اعتداء على كل فرد في المجتمع ينتفع بها ويستفيد منها، وبالتالي فالاعتداء عليها جريمة من أكبر الجرائم، وإثم من أكبر الآثام، وذلك لأن مثل هذه الاعتداءات يتضرّر منها العدد الكبير الذي لا حصر له من الناس، فيتعدّد الإثم بتعدّد من لحقه الضرر.
ولو ضربنا لذلك مثلاً بالاعتداء على محطات وخطوط الكهرباء، فإننا سنلاحظ مدى الأضرار الفادحة التي تلحق بالناس جرّاء هذا العمل الإجرامي الخبيث، ابتداءً بحالات الوفاة التي قد تحدث نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وتعذّر إنقاذ بعض الحالات بأجهزة التنفس الصناعي، أو غيره من الأجهزة الطبية التي تستخدم عادة في أقسام الطوارئ وغرف العمليات وغرف العناية المركزة في المستشفيات والمراكز الطبية، وانتهاءً بتعرّض الكثير من التجار للخسائر الفادحة نتيجة توقّف الأجهزة التي تقوم بحفظ ما يحتاج إلى الحفظ كالثلاّجات والمكيّفات ونحوها، و تعطّل مصالح الناس -خصوصاً أصحاب الأعمال والمهن- نتيجة توقّف الآلات التي هي أساس عملهم ومصدر رزقهم كآلات الخياطة وآلات الطباعة والتصوير وغيرها.
وقس على ذلك جرائم الاعتداء على الطرق العامّة والجسور، وما قد يحصل نتيجة ذلك من تعطيل لمصالح الناس، وإلحاق الخسائر والأضرار الفادحة بالأرواح والممتلكات، وهكذا الأمر في سائر المشاريع الحيوية والخدميّة المتّصلة بحياة الناس ومصالحهم.
ونتيجة لكل تلك النتائج التي تحدثها هذه الأعمال التدميرية لمصالح الناس العامة والخاصة فإنّه قد تصعب التوبة -إن لم تكن متعذّرة- على من يرتكب مثل هذه الجرائم، وذلك لأنّ من شرط التوبة مما يتعلّق بحق المخلوقين التحلّل من الذنب الذي وقع عليهم، إمّا بإرجاع حقّهم، أو تعويضهم عمّا فات من حقّهم، أو الاعتذار إليهم وطلب السماح منهم، وكل هذه الأمور مستحيلة ومتعذّرة في مثل هذه الحالات.
فهل يعي من يرتكبون مثل هذه الجرائم –ومن يؤيدهم ويشجعهم ويتعاون معهم- بعظيم ما يرتكبونه من جرم، وما يتحمّلونه من وزر، وما يلحقونه من أضرار فادحة بأنفسهم ووطنهم وأبناء جنسهم؟؟
وإذا كان أمثال هؤلاء الحمقى يظنّون أنّهم قادرون على الإفلات من يد العدالة في الدنيا حيث لا رقيب عليهم ولا حسيب، فليعلموا أن الله لهم بالمرصاد، وهو الرقيب عليهم والحسيب، قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) صدق الله العظيم.
- قرأت 16 مرة