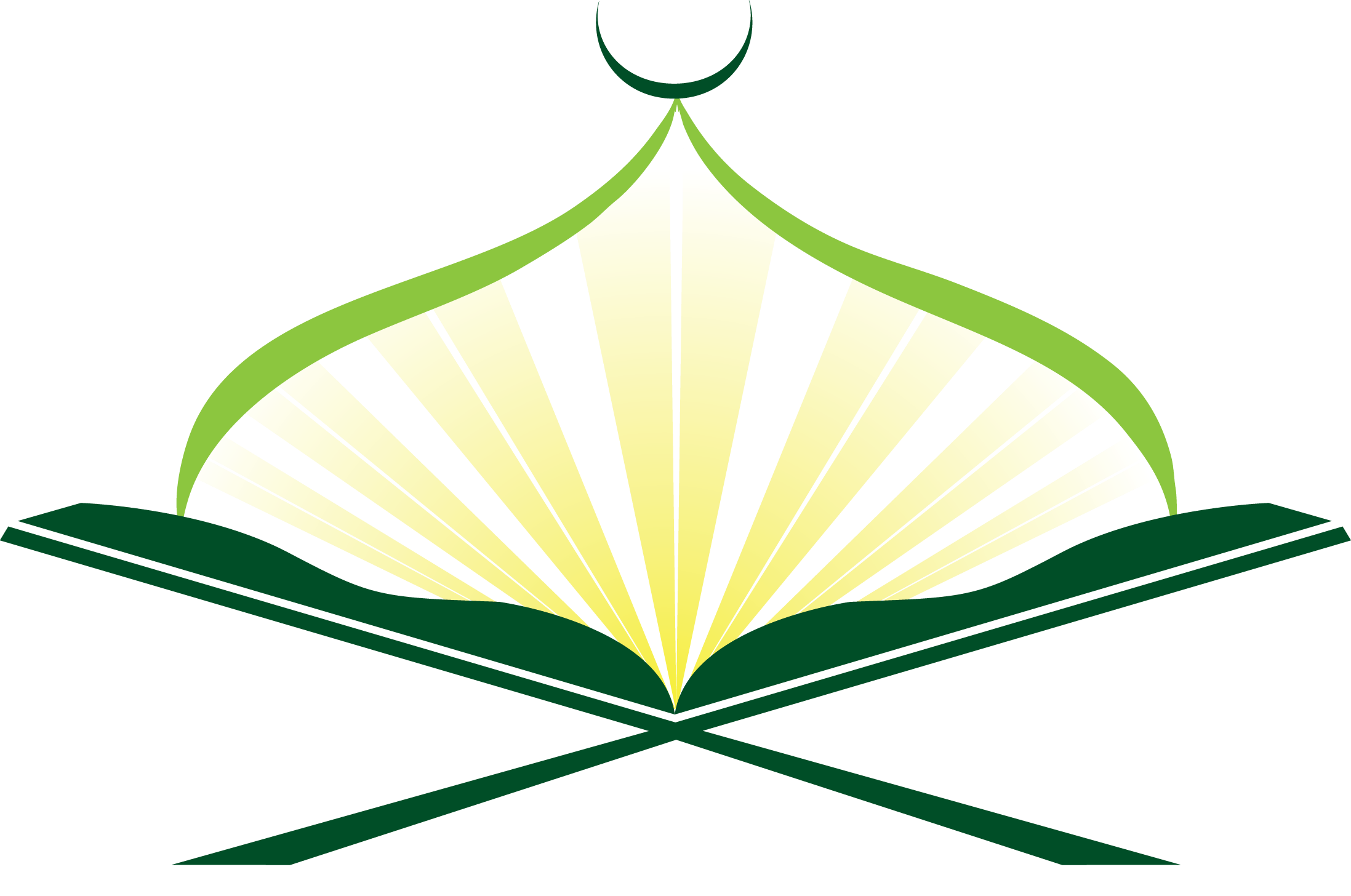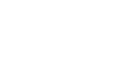القاسم الرسّي شاعر من طراز فريد

أعارك ماله لتقوم فيه بطاعته وتعرف فضل حقه
فلم تشكر نعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه
تبارزه بها يوماً وليلاً وتستحيي بها من شر خلقه
هكذا تبلورت شاعرية الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (169-246هـ) نظماً إرشادياً بليغاً يعكس فلسفته الخاصة عن الكون والمجتمع، وعلاقتهما بالخالق تعالى.
وإذا كانت نهايات القرن الثاني الهجري قد مثلت مرحلة التطور والنضج في مفردات الشعر العربي وأغراضه وصوره من خلال تجاوز البنية العامة للقصيدة العربية في عصرها الجاهلي، والتجديد في صوره المعبرة وألفاظه الدالة.
والإمام القاسم الرسي كشخصية علمية مرموقة لم يكن بعيداً عن تلك التغييرات الجوهرية التي طرأت على بنية النص اللغوي شعراً ونثراً، حيث اختط لنفسه منهجاً خاصاً استطاع أن يؤسس على ضوئه مدرسة شعرية فريدة تميزت بتعدد أغراضها وعمق دلالاتها وجزالة ألفاظها وسهولة تعابيرها، وبما ان القاسم الرسي كان داعية ومصلحاً اجتماعياً، وثائراً مجدداً في منظومة الفكر الإسلامي والسياسي فإنه قد وظف ملكته الشعرية في نشر معالم فكره ورسالته التي ناضل من أجل تحقيقها، وتحمل في سبيلها العنت والمشقة.
ومن خلال استنطاق المضامين الدلالية لمفردات شعره الرائع تجد أن تلك المشاعر الجيّاشة والوجدان الصافي الذي يطمح إلى نشر الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، ويحلم بتأسيس مجتمع القيم النبيلة القائم على الطهر والاستقامة، والإدراك الواعي المتناغم مع مفردات الوجود في حركيتها ونظامها والتزامها الدقيق بوظائفها المحددة لها.
ولهذا فجل مقطوعاته الشعرية تدور حول إشكالية السلوك الشخصي للأفراد وطرائق إصلاحه، ومقاومة العوامل التي تنحرف به عن مساره الصحيح. فها هو يحارب اليأس والقنوط والتذمر الساخط، لأنه لا يغير من واقع الحال شيئاً بقدر ما يثبّط الهمم، ويهد أركان العزيمة حيث يقول:
فلا تجزع إذا أعسرت يوماً فقد أيسرت في الدهر الطويل
ولا تيأس فإن اليأس كــــفر لعل الله يغني عن قليـــــــــــل
ولا تظنن بربك ظن ســـوء فإن الله أولى بالجميـــــــــــــل
كما أتخذ من شعره مدرسة تعليمية ينشر من خلالها مفردات مذهبه، ويصحح بها تلك المغالطات التي اقتحمت مجالات الفكر الإسلامي ومنظومته العقدية حيث يقول:
إني أمرؤ مذهبي التوحيد أظهره والعدل أبديه تارات وأخفيه
ما كلف الله نفساً فوق طاقتهـــــا ولا يعاق إلا بعد تنبيــــــــه
ولا يعذب طفلاً ما جنى أبــــــداً بذنب آبائه في النار يخزيـه
ويزخر شعره بالحكم المعبرة أمثال قوله:
كفاف امرىء قانع قوتُه ومن يرضَ بالعيش نال الغنى
وقوله:
فإني وما رمت في نيلـــــه وقبلك حب الغنى ما ازدهر
كذي الداء هاجت له شهوة فخاف عواقبها فاحتمــــــى
ولم نجد في شعره مجالاً للغزل أو المدح، فدوره الإصلاحي لا يرتضي له الانحدار إلى مستوى الترقية عن النفس أو الهرب من الواقع.
وإذا كان السلوك الإنساني في أمسّ الحاجة إلى ما يحفزه على العمل والاستقامة ويردعه عن الانحراف، فإن أفضل وسيلة تم توظيفها في أدبيات الفكر الإسلامي لمعالجة ذلك الشعور الملحّ بأهمية الحوافز والدوافع في إثارة النفس لممارسة السلوك او تركه قد تمثلت في تذكير الإنسان بمصيره المحتوم بعد الموت، والتأكيد على ان الفرد هو من يرسم ملامح مستقبله الأخروي من واقع ممارساته وتصرفاته السلوكية، ومعتقداته الفكرية في حياته الأولى، وهذا ما استلهمته الغمام القاسم في حركته الدعوية حيث ربط الشعر بوظيفة التذكر والتأكيد على ضرورة الالتفات على عوالم الآخرة والاستعداد لها، وهو يعتبر الإيمان باليوم الآخر وما يترتب عليه من استعداد وتأهب من أقوى المثيرات السلوكية التي تدفع صاحبها إلى مراجعة نفسه وتعديل نمط تصرفاته، والارتقاء بها إلى الأفضل كقوله:
أترقد والمنايا طارقــــــــــــات؟ ولا تغترّ في طول الحيـــــــــــــــاة
تزوّد من حياتك للممـــــــــــات كأنك قد أمنت من البيـــــــــــــــات
أتضحك أيها العاصي وتلهـــــو ونار الله تسعر للعصــــــــــــــــات
أتضحك يا سفيه ولست تــدري بـأي بشــــــارة يــــــــأتيـــــــك آت
فيا قلبي فلم تزدد رجوعــــــــاً وتعرض عن عظات ذوي العظات
ومن خلال النص السابق ندرك ذلك الاهتمام بتفعيل الدلالات اللغوية لمفردات الحقل المعجمي والمحافظة عليها من الضياع والذوبان في الدلالات الجديدة التي أقحمت عليها في العصر العباسي تحت ما عُرف بقانون (التوليد الدلالي)، وذلك بمعنى الجهل والطيش، وعدم استعمال العقل وتحكيمه كقوله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)، بمعنى من لم يبلغوا الحلم أو من لم تنضج عقولهم وتتفتح مداركهم. وهو هنا يجافي المعنى الدارج الذي يعني بالسفيه المنحرف سلوكياً أو المتمرد على منظومة القيم والأعراف.
وفي سياق الارشاد والتقويم السلوكي يقارن الإمام القاسم بين تعاملات الانسان مع مفردات الدنيا وتملقه لأربابها لكسب ودهم ونيل الحظوة عندهم، وبين إعراضه عن عالمه الأخروي الحقيقي، وتجاهله، وإعراضه عن خالقه تعالى وذلك من خلال توظيف التقابلات الضدّية بين مفردات النص لإبراز جماليته الفنية من جهة، وإيقاظ الأذهان والقلوب من خلال تداعيات تلك العلاقة الضدّية، وما تحيل إليه من معان تبرز المقصد الحقيقي الذي يسعى النص لإيصاله إلى ذهن المتلقي من جهة أخرى، وذلك في قوله:
مضى عمري وقد حصلت ذنوب وعــزّ عــليّ أنـــي لا أتــــــوب
نُطَهر للجمال لنــــــــا ثيابـــــــــاً وقـــد صدئت لقسوتها القلــــوب
وأعربنـــا الكـــلام فمـا لحسنّــــا ونلحن في القعال فلا نصيـــــب
فالتقابل الدلالي فيما بين (نطهر) بمعناها الذي يشير على النظافة والجمال المرتبط بالمظهر الخارجي الذي عبر عنه بمفردة (الثياب)، وبين (صدئت) بما تحمل من معاني القبح وتغيير الشكل والإهمال، وارتباطها الدلالي بالمظهر الداخلي الذي عبّر عنه النص بـ (القلوب)، كل ذلك قد أفصح عن تلك المفارقة العجيبة في تعاملنا الإيجابي مع عوالم الحياة الدنيا ومظاهرها البراقة الزائفة، وتجاهلنا السلبي لمقومات الحياة الحقيقية الكامنة وراء حجب الغيب بخلودها ونعيمها الأزلي.
والنص السابق تمثل دعوة ضمنية إلى الموازنة والاعتدال في تعاطينا مع مفردات واحتياجات كل حياة، وعدم تغليب إحداها على الأخرى، فالإقبال على الآخرة في فلسفة الإمام القاسم لا يتعارض مع رغبة الإنسان في التمتع بالحياة وعيش كل لحظاتها ما دامت مقترنة بالاستقامة التي دعا إليها الشرع الحنيف.
كما أن الإمام القاسم لم يكن غافلاً عن الآثار المترتبة على انحرافات المجتمع عن مبدأ الالتزام العملي التطبيقي بالزامات المقولات اللفظية بمعنى مخالفة الأعمال للأقوال، وهذا ما ألمح إليه القاسم في قوله:
وأعربنـــا الكـــلام فمـا لحنـــا ونلحن في القعال فلا نصيـــــب
وإذا ما استحضرنا الدلالة المعجمية لمفردة (الإعراب) وجدناها تدور حول معاني البيان والإفصاح والتوضيح، بينما تشير مفردة (اللحن) إلى الانحراف والخطأ والخلل، وربط تلك الدلالات بمقصدية البيت السابق تشير إلى أن أفراد المجتمع بطبيعتهم الإنسانية بارعون في الإفصاح عن مقاصدهم، والتعبير عن توجهاتهم وما يختلج في صدورهم من أحاسيس ومشاعر وتطلعات، ولكنهم يخطئون في ترجمة تلك الأقوال إلى ممارسات عملية جادة، وهذا ما حذرت منه الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ).
وكأن الإمام القاسم يريد أن يلفت انتباهنا إلى مقصدية الآية السابقة، والعودة إلى استحضار ثقافة القرآن الكريم في كل حركاتنا وسكناتنا، فهو دستور الحياة الخالد، وقانون الفضيلة الاستقامة.
إن المتتبع للأغراض الشعرية التي تطرق إليها الإمام القاسم الرسي في شعره يجد أنها تدرجت بوعي وإدراك المتلقي في مدارج الكمال والاستقامة وفق منظومة معرفية، وقيم سلوكية مستمدة من وحي الدرس القرآني في تعاطيه مع فكرة الحياة والإنسان والعمل والمعتقد، لتتحول تلك المقطوعات القصيرة والقصائد الطويلة إلى مدرسة علمية تعكس فكر الإمام القاسم، وثقافته الموسوعية الشاملة، وحرصه على تبليغه إلى الناس عبر بلاغة الكلمة نثراً وشعراً.
وخير وصية تربوية تختتم بها هذا العجالة هي دعوة الإمام القاسم إلى استثمار أوقات الفراغ فيما يعود على الإنسان بالنفع والفائدة، وتوظيف الكلام العابر في تعطير الأجواء بالذكر والتسبيح، حيث يقول:
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغاً مستريحاً
وإذا هممت بالزور الباطل فاجعه مكانه تسبيحــــــاً
فالفراغ وحده هو ما يدفع الإنسان إلى اقتحام عتبات الخطيئة عبر بوابة اللهو والعبث، كما أن اللسان عندما يعجز عن اعتلاء منابر التوجيه والإرشاد والبناء، فإنه سوف يتخدر إلى مهاوي الكذب والباطل، وتزيف الحقائق، وتشويه معالم كل مظهر جميل، وتوجه صائب، وهو ما حذر منه القاسم الراسي بقوله:
|
ما لكريم النصاب والكــــذب؟ |
|
ذاك فعال اللئام في الحســـب |
|
لو أُعطي الحرُ أن يفه كذبــــاً |
|
ملك جميع الملوك من عـرب |
|
ما رضيَ الحرُّ أن يميل بـــــه |
|
لزعمه من زعائم الكـــــــذب |
|
والزور أمرٌ قلاه خالقنــــــــــا |
|
وذمّهُ في منزل الكتـــــــــــب |
|
والعبـــد إلف لـــه يقلبــــــــــه |
|
يميل منه في كل منقلــــــــب |
|
يكذب غما لرغبــة طمعـــــــاً |
|
أو رهبة للمجون واللعـــــــب |
|
أعيذ نفسي ومن ولدتُ ومـــن |
|
أحببت من قول كل مكنتــدب |
- قرأت 60 مرة