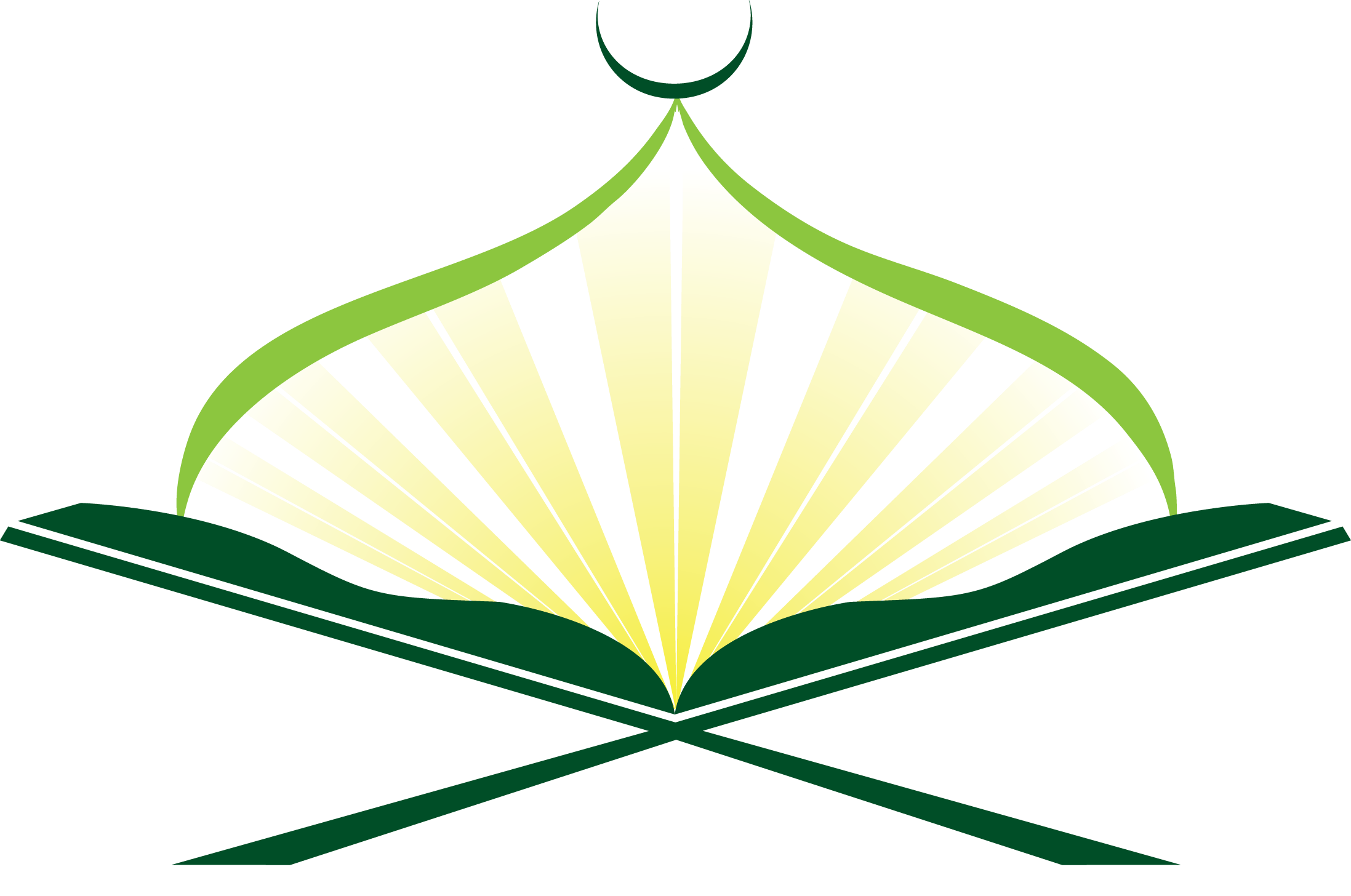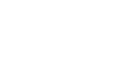تأملات في الفتح المبين "فتح مكة"

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد الصادق الأمين، وعلى آله الظاهرين، وصحابته المنتجبين.. وبعد:
يعتبر فتح مكة نقطة تحول في تأريخ الدعوة الإسلامية؛ كونها حررت تلك البقعة المباركة من أسر الكفار وبراثن المشركين، وأعادت العاصمة الإسلامية إلى أهلها؛ لتؤدي دورها الدعوي بالشكل؛ الذي هُيَّأت له؛ منذ اختارها الله مكاناً للكعبة: قبلة المسلمين وعنصر وحدتهم؛﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير﴾[الحديد:10].. وإذا أردنا أن ندرك دلالات وأبعاد هذا الفتح؛ فعلينا أن نستنطق سورة (الفتح)؛ التي تمثل تشخيصاً دقيقاً لهذه الحادثة؛ وترسم أبعاده الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل هذا الإسلام ومآله، وهذا يتطلب منا أن نقف على محطات من سورة الفتح..
دلالة الفتح:
يشير المدلول اللغوي لكلمة (الفتح) إلى الظفر بأرض مكة قهراً أو صلحاً، وتحريرها من سيطرة المشركين، وهذا يعني أن الله أختار تلك البقعة مكاناً لبيته الحرام، ومنطلقاً للدعوة الإسلامية؛ فلا ينبغي أن تظل في أيدي المشركين؛ لأن ذلك يؤثر على دورها الحيوي المعدة له؛ كمركز للدعوة الإسلامية ومحور انطلاقها؛ ولذا لا بد من إعادتها إلى أهلها؛ فجاء الوعد الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفتح عقيب منصرفه من الحديبية؛ بصيغة الماضي (فتحنا) التي تفيد التحقق والوقوع.. وإذا وسعنا النظر في مدلول (الفتح)؛ سنجد أنها قد تأتي بمعنى الفصل بالحكومة؛ كما ورد في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين﴾، أو بمعنى النصر على الأعداء؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾، وغيرها من المعاني التي تدل عليها كلمة (الفتح)، والتي تشير في مجملها إلى وجود حاجز مغلق يمنع من تحقيق المطلوب أو إكماله، ولذا يكاد اسم (الفتح) بما لها من دلالات يقتصر على أرض مكة، رغم وجود انتصارات كثيرة في تأريخ الدعوة الإسلامية؛ وكأن مستقبل الإسلام يرتبط في جزء وثيق منه بتلك البقعة المباركة التي اختارها الله تعالى مكاناً لانطلاق الدعوة العالمية؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾؛ فإذا ما تعرضت هذه البقعة للاحتلال؛ فسيمثل ذلك جزءاً من الإعاقة أمام انتشار الدعوة الإسلامية؛ لفقدان مركزها الأساسي؛ ويمكن أن نضرب مثالاً بحال الإسلام اليوم؛ الذي يعيش حالة انحسار في رقعة العالم؛ وقد يكون من أسبابه؛ هو تحول تلك البقعة إلى يد آل سعود وتصرفهم؛ بدعم بريطاني، ومساندة أمريكية؛ ليظهر إلى السطح إسلام مشوه؛ بشكل سعودي، وحركة داعشية، وعقائد وهابية؛ أورثت الإسلام ضعفاً، وزادت المسلمين تفرقاً وتمزقاً؛ وكأن البريطانيين أدركوا الدور الاستراتيجي لتلك البقعة في حركة الإسلام التوسعية؛ فسعوا إلى السيطرة عليها بطريقة ملتوية؛ تخدم أهدافهم الاستعمارية، وتقلص من حركة الإسلام؛ ولذا لابد أن يتنبه المسلمون على ضرورة تحرير تلك البقعة المباركة من يد آل سعود؛ الذين أفرغوها من محتواها الرسالي؛ حتى وصل بهم الأمر إلى منع الحج بأعذار واهية؛ وقد أشار الله تعالى إلى أن أحد أسباب فتح مكة بتلك الصورة المهينة للكفار؛ هو صدهم عن المسجد الحرام: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾[الفتح:25].
فتحاً مبيناً:
يشير قول الله تعالى: (فتحاً مبيناً) إلى واقعية هذا الفتح المتجاوز للطموحات والآمال؛ وكأن المسلمين كانوا يستبعدون مثل هذا الفتح؛ خصوصاً وأن مكة كانت تحت قبضة الكفار وسيطرتهم؛ ولهذا كان لا بد من الدفع بالنبي ومن معه إلى هذا الفتح على خطوات مرتبة؛ ابتدأت بشكل فعلي؛ من إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إرادته للمسير إلى مكة معتمراً عام الحديبية في السنة السادسة للهجرة، واستنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فلما رأى رسول الله تثاقل كثير من الأعراب عن المسير معه، كان لا بد من أخذ البيعة من المسلمين؛ كميثاق مؤكد على الصبر والثبات على مواجهة كفار قريش؛ وقد صور الله هذا المشهد من جانبين؛ جانب المؤمنين المبايعين لرسول الله على النصرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، وجانب المتخلفين من الأعراب: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا * وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾[الفتح:13].. وهذا يصور لنا على جهة الإجمال حجم الخوف والقلق من كفار قريش؛ إلى الدرجة التي دفعت المذبذبين لاختلاق الأعذار، ودفعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أخذ المواثيق المؤكدة من المؤمنين على النصرة والثبات من خلال البيعة، وهذا يعني أنهم كانوا يستبعدون فتح مكة؛ وخصوصاً وقد رأوا كيف صد القرشيون رسول الله ومن معه من دخول مكة وأداء العمرة، وقد كانت قريش قد تهيأت للقتال؛ لكنها فوجئت أنّ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا يرتدون إحرام العمرة، لذا عدلت عن نية القتال، ومنعوا النبي صلى الله عليه وآله من أن يدخل مكة في هذا العام بعدما وقّعوا معه وثيقة صلح؛ ليقوم النبي صلى الله عليه وآله على إثرها بحلق شعره في الحديبية ونحر هديه، وهنا تتابعت الخطوات التمهيدية لفتح مكة في اتجاهين:
- طمأنة المسلمين، وإنزال السكينة على قلوبهم بصدق وعد الله تعالى؛ حتى يتمكنوا من المسير بوعي، والحركة بثبات؛ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾[الفتح:18].
- فتح خيبر؛ التي وقعت في السنة السابعة، وحاصر فيها النبي ومن معه حصون اليهود، وغنم منهم أموالاً وعقارات كثيرة، وقد مثّل هذا الانتصار رعباً في قلوب القريشيين؛ إذ رأوا في النبي صلى الله عليه وآله ومن معه قوة عظمى لا يستهان بها؛ مكنته من الانتصار على جبروت اليهود وطردهم من آخر معاقلهم: ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ (في فتح خيبر) وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا (فتح مكة) قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾[الفتح:21]، وهاتان الخطوتان وقعتا في غضون سنتين؛ فإنزال السكينة على قلوب المؤمنين المبايعين لرسول الله على النصرة كانت عقيب صلح الحديبية في السنة السادسة؛ والتي مثلت لهم طمأنينة عجيبة؛ لما رأوا من نتائج الصلح؛ التي تسير في الغالب لصالح المسلمين، وفتح خيبر وقعت في السنة التي تليها السنة السابعة؛ فقد شاهد المسلمون فيها صدق وعد الله تعالى، وضعف اليهود رغم إمكانياتهم الهائلة، وحصونهم الشاهقة؛ فأخذوا من ذلك درساً إلهياً؛ أن الكفار في خيبر أو في مكة على نفس الشاكلة من الضعف؛ ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا * سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً﴾[الفتح:23]، وفي الجهة المقابلة؛ كانت النفسية الانهزامية قد غلبت على كفار قريش؛ فما إن تدخل السنة الثامنة، وتحديداً في شهر رمضان؛ حتى يفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه مكة بدون حرب وسفك دم سوى مناوشات وقعت في أطراف مكة سرعان ما هدأت؛ ليسيطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مفاصل الأرض؛ كما حكى الله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾[الفتح:24].. وهنا يتبين للمسلمين في الماضي والحاضر كيف تضعف القوى وتسقط الماديات وتتغير الموازين أمام إرادة الله تعالى وتحقيق وعده، وكأنه يفتح نافذة مضيئة أمامهم عن مستقبل الإسلام وإمكان انتشاره في كل رقعة من هذا العالم؛ في حال ما إذا وجد من ينصر الله ويجند نفسه لخدمة هذا الدين وهداية الأمة، ولا شك أن كل القوى العالمية ستسقط؛ كما حدث في فتح مكة؛ الذي أسقط جبروت الكفار، ولم يكن ليتوقعه المسلمون؛ لولا أنه مَثَّلَ (فتحاً مبيناً) لا شك فيه.
أبعاد الفتح:
وهنا يتعدى فتح مكة إطاره المكاني إلى المفهوم الواسع الشامل للفتح المعنوي؛ والذي يعني فتح الآفاق الواسعة تجاه دعوة الإسلام وحركته العالمية؛ ويظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾[الفتح:3-2]؛ قال الزمخشري في الكشاف: (فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة، قلت: لم يجعل علة للمغفرة، ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة؛ وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك؛ لنجمع لك بين عز الدارين، وأغراض العاجل والآجل).. بمعنى أن فتح مكة كان نتيجة حتمية؛ لاستكمال البنية التحتية للدولة الإسلامية؛ بانضمام مكة إليها؛ كونها تمثل قبلة المسلمين وعنصر وحدتهم، واستتمام المنظومة التربوية؛ لما يمثله الحج من أهمية في تقويم الإنسان وتربيته؛ ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾[المائدة:97]؛ ليكتمل بذلك بناء الدولة الإسلامية؛ ببنيتها التحتية ومنظومتها التربوية؛ ويتحقق بذلك غرضان: الأول؛ خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره رسول الأمة وقائدها؛ والذي سيستمر بوجوده المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، وكلها لا شك سينعكس على واقع المجتمع الإسلامي؛ ليتحقق في أوساطه الغرض الثاني؛ ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا * وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾[الفتح:6].. ولا شك أن دولة كهذه –تملك قيادة ربانية، وفي مجتمعها المؤمنون والمؤمنات؛ الذين يجسدون الإيمان والعمل الصالح في أرقى مستوى، بينما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات في دائرة السوء؛ مقيدين بنظام الدولة وقانونها الدستوري الحازم- سيكون لها آفاق واسعة، وفتوحات مستمرة؛ كما يفهم من صيغة المضارع: (يغفر)، (يتم نعمته)، (يهديك) (ينصرك)؛ التي تفيد التجدد والاستمرار، وتصاحب انتشار الإسلام وتمكينه في بقاع الأرض؛ لأن المغفرة سبب لتمام النعمة، وتمام النعمة سبب إلى الهداية، والهداية سبب لتحقيق النصر العظيم.. وعلى ذلك ففتح مكة يمثل استكمالاً للأسس؛ الذي يمكن من خلالها نشر الإسلام العالمي في كل بقعة من هذه الأرض، ويمكن أن نجمل تلك الأسس في الآتي:
- وجود القيادة الربانية؛ كما تدل عليها الآيات التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ من نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[الفتح:8]، وتحدث في الآية التي تليها عن مهمة هذه القيادة؛ والتي تتمثل في تربية الأمة على الإيمان بالله ورسوله، وخلق حالة التقوى في حياتهم، والمبنية على تعظيم الله تعالى واستشعار مراقبته في كل حين؛ ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾[الفتح:9].
- وجود الجماعة المؤمنة الواعية؛ التي تجند نفسها لله ونصرة دينه، ويحملون المواصفات التي ذكرها الله تعالى في ختام السورة: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾[الفتح:29].. ولابد أن يكون لهذه الجماعة عمل منظم وحركة واسعة؛ تسعى في اتجاهين متوازيين؛ وهما: نشر الإسلام؛ بما يحويه من فكر وخُلُق ونظام، وجهاد كل من يقف في وجه الإسلام ويتعرض لعقيدته ونظامه من الكفار والمنافقين؛ ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾[الفتح:16].
- مراعاة أن تكون نقطة الدعوة الإسلامية، ومحور الحركة الرسالية من مكة؛ كعاصمة حاضنة لها؛ وإن لم يكونوا قاطنين فيها؛ لما لهذه البقعة المباركة من خصوصية؛ كونها مهوى الأفئدة، وعنصر الوحدة لكافة المسلمين؛ كما يظهر من حادثة فتح مكة؛ وهذا يتطلب من المسلمين أن يحرروا تلك البقعة من قبضة آل سعود؛ إذا أرادوا أن يعيدوا حيوية الإسلام وحركته، وإزالة الصراعات والتمزقات داخل الكيان الإسلامي.
مستقبل الإسلام:
وإذا وجدت هذه الأسس لدى الأمة الإسلامية؛ فلا شك أنها ستحدث فتحاً يفوق الجغرافيا المحدودة، ويسود الإسلام العالم؛ برسالته العالمية، ونهجه الشامل؛ وقد أشار الله تعالى في سورة الفتح إلى وجود عوامل تساعد على إحداث هذا الفتح الشامل لرقعة الأرض؛ والتي منها:
- أن أعداء الإسلام -سواء كانوا من الكفار أو اليهود- ضعيفون للغاية، ولا يمكنهم أن يثبتوا في أي مواجهة مع المسلمين؛ كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا *سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً﴾[الفتح:23]، وقد شخص الله سبحانه سبب ضعفهم، والناتج من حب الدنيا والتعلق بالمادة؛ ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾، إلى جانب سوء الظن بالله وبصدق وعده؛ ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾[الفتح:12].. ولا شك أن الكفار اليوم بكل مستوياتهم يحملون هاتين الصفتين بقوة؛ بما يجعلهم غير قادرين على الصمود أمام الحركة الإسلامية الثابتة.
- القابلية لهذا الدين، وإمكان انتشاره بسهوله؛ كونه يحمل المبادئ الفكرية والأخلاقية؛ التي تلائم فطرة الإنسان، ويمتلك النظام الملائم لطبيعة المجتمعات المختلفة وحاجتها؛ كما أشار إليه المولى تعالى بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا﴾[الفتح:28]؛ ولا شك أن المراد بإظهار هذا الدين على كل الديانات؛ هو هيمنته وقابليته للانتشار في المجتمعات العالمية بكافة مستوياتهم؛ في حال بلغهم هذا الدين بنقائه وصفائه وشموله؛ فإنه لا شك سيظهر على كل الديانات؛ لكونه يملك النظام الشامل؛ التي تحتاجه البشرية؛ لطهارة حياتهم واستقراره، ومن يتتبع الانظمة العالمية المختلفة؛ سيجد أنهم يلجئون في آخر المطاف إلى الرجوع إلى بعض الأنظمة الإسلامية وقوانينه، وضرب الأمثلة في ذلك يطول.
درس عظيم:
من أعظم الدروس؛ الذي يمكن أن نستفيد منه في فتح مكة؛ هو كيفية التعامل مع المخالفين؛ فهناك من يظهر عداوته للمسلمين، وهناك من يعيش في مجتمع الكفار، و يخفي إيمانه؛ لأسباب مختلفة، وقد صور لنا الله مشهد المخالفين المتذبذبين؛ الذين يتقربون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه؛ بالقدر الذي يحقق مصالحهم فقط؛ فإذا وجدوا خطورة في اتباع رسول الله قالوا ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾، وإذا لم يجدوا في ذلك خطورة، وشعروا بوجود مصلحة لهم، قالوا ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾؛ فمثل هؤلاء قد يظهرون في أي مجتمع إسلامي، لكنهم يتفاوتون في الظهور والاختفاء؛ فالبعض يظهر منه اتباع المصلحة، والبعض يمتلك قدرة فائقة في إخفاء مصالحه، والظهور بمظهر المصلح المخلص؛ فالتعامل مع هؤلاء -وبالأخص ممن ظهر منه الانحراف- تكون بالمقاطعة الصارمة لهم والتخلي عن خدماتهم؛ ﴿قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ﴾، وقد أخبر تعالى عن ردة فعلهم، وأنهم سيحولون القضية عن مسارها، ويشيعون أن ذلك نتيجة خلاف شخصي، ولا صحة لما يشاع عنهم؛ لأن ذلك ناتج عن وجود حسد بينهم؛ ﴿فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾، وهنا يضع تعالى أسلوباً مهماً في كشف حقيقتهم؛ وهو أن يدعوا إلى الجهاد والتضحية بالنفس، بعد ان يُبعدوا من المراكز الحساسة؛ ليتضح إن كانوا يهتمون بالإسلام حقيقة أم كانوا يسعون لتحقيق مصالح شخصية؛ ﴿قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾[الفتح:16].. وهذا لا شك تعامل صارم لا تهاون فيه؛ لأن وجوده سيؤدي إلى تشويه الإسلام واضطراب المجتمع الإسلامي.. وفي المقابل نلاحظ أن هناك فئة مؤمنة كانت تقطن مكة، وتخفي إيمانها خوفاً من بطش كفار قريش؛ حتى لم يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد راعى تعالى وجودهم في مكة، وهيأ أن يكون الفتح بالطريقة السلمية؛ حتى لا يتعرض المؤمنون والمؤمنات للقتل والتشريد؛ ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾[الفتح:25].. فيمكن أن نستفيد من هذا أن تصنيف الناس إلى مؤمن وكافر لا يحددان بالمقاييس الحركية الشخصية، بل بالمعايير الربانية؛ فربما حكم شخص ما على أمثال هؤلاء بالكفر؛ لأنهم في ديار الكفار، أو لم يتحركوا للجهاد مع رسول الله، أو لم يتخذوا موقفاً ما، أو غير ذلك مما أراه معياراً صحيحاً في تصنيف الآخرين، وبالتالي؛ فهناك معايير ثابتة وقطعية، وهناك معايير نسبية ظنية، وما علينا إلا استخدام المعايير القطعية في تصنيف الناس، وترك ما عدا ذلك على الله تعالى.. وهناك درس آخر؛ يتلخص في أهمية مراعاة جانب المؤمنين في الحروب؛ فبمجرد الظن أن في قرية ما أو مدينة جماعة من المؤمنين والمؤمنات؛ قد يتعرضون للقتل؛ إن أطلقت صاروخاً أو اقتحمت تلك المنطقة؛ فما عليَّ إلا أن أترك ذلك، واتخاذ البدائل المختلفة؛ التي يمكن لها أن تحافظ على الفئة المؤمنة؛ حتى لا تصيبنا معرة- وهي السمعة السيئة أو الإثم- بغير علم، وهذا فيه دلالة على أهمية الفرد المؤمن عند الله تعالى، ولذا وجب الحفاظ على حياتهم وعدم إهدارها.
- قرأت 34 مرة